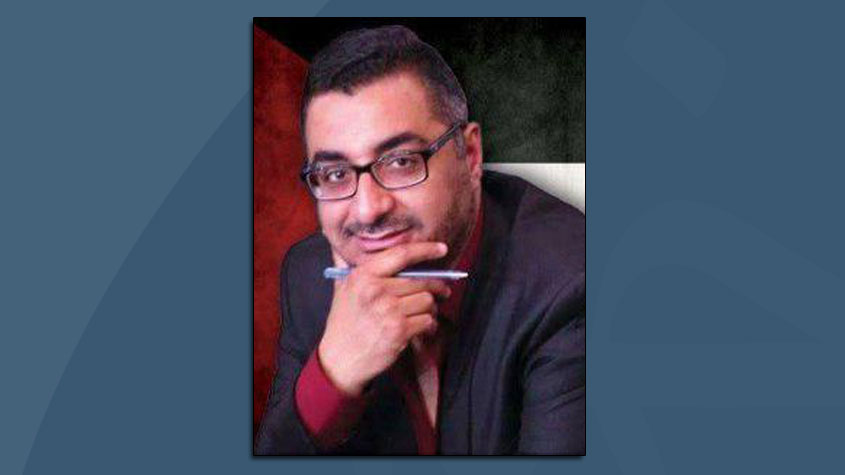الفلسطينيون في صفحات فارغة!
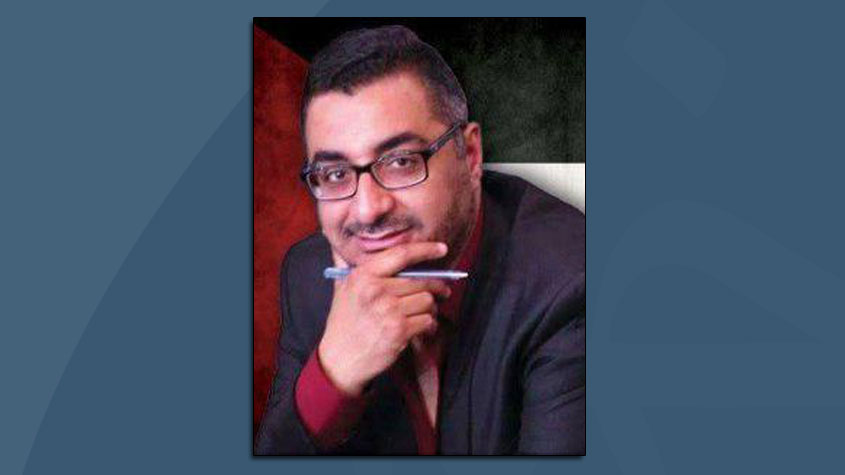
أحمد الدبش
الفلسطينيون ضاربون في التاريخ ولم يكونوا رعاة لا يعنيهم كثيراً أن يستقروا (أ ف ب)
«تاريخ الشعب الفلسطيني: من العصور القديمة إلى العصر الحديث»A History) of the Palestinian People: From Ancient Times to the Modern Era)، هو كتاب للمحاضر السابق في جامعة حيفا، أساف وول (Assaf A.Voll)، يقع في 120 صفحة، باللغة العبرية، ترجمه إلى اللغة الإنجليزية، ألان سلاتر.
يباع هذا الكتاب على موقع «أمازون/ amazon» العالمي، بسعر 7.99 دولارات أميركية. وقد وُصف الكتاب بأنه «ثمرة سنوات عديدة من البحث في آلاف المصادر وبشكل دقيق في مراجعة المكتبات ودور المحفوظات (الأرشيف) في جميع أنحاء العالم، لإنتاج ما يعتبر المراجعة اﻷكثر شمولاً واتساعاً لـ3000 سنة من المساهمة الفريدة للشعب الفلسطيني للعالم واﻹنسانية». وتشير التعليقات على الكتاب في الموقع، إلى أنه «كتاب معمق ويستند إلى بحث طويل»، وأضحى هذا الكتاب، يتصدر مبيعات الموقع، قبل إزالته من الموقع لأسباب غير واضحة بعد.
نشر كتاب فارغ الصفحات عن الفلسطينيين يعني أن لا تاريخ لهم!
وقد أوضح أساف وول، مؤلف الكتاب، الدوافع وراء كتابته إلى محطة الإذاعة الدينية الصهيونية «كول هاي/ Kol Hai»: «الشعب الفلسطيني يعتقد أنه شعب، ويحتاج إلى شخص ما يقول لهم الحقيقة حتى لو كان ذلك مؤلماً. انظر ماذا يحدث عندما يعطى لهم الشعور بأنهم شعب حقيقي». تشير جريدة «هآرتس» الصهيونية، في 22 حزيران/ يونيو؛ إلى «أن حجة وول بأن الفلسطينيين ليسوا شعباً، فلا تاريخ لهم، فهم حديثون، هو عماد الحق اﻹسرائيلي، الذي ادعى أن القومية الفلسطينية اخترعها القادة العرب من أجل تدمير إسرائيل».
والهدف من هذا الكتاب، حسب ما نشر في موقع breakingisraelnew، هو أن يكون «الكلمة الأخيرة في موضوع التاريخ الفلسطيني».
الحقيقة أنّ هذا الكتاب، جاء فارغاً تماماً في داخله، وأنه مجرد 120 صفحة من الورق الأبيض، ولا يحمل أي كلمة، أراد أساف وول من نشره إيصال رسالة مفادها أنه قرر تأليف كتاب فارغ الصفحات عن الفلسطينيين، لأن الشعب الفلسطيني، فارغ، لا تاريخ لهم!
ما لم يقله أساف، أنّ الكيان الصهيوني، هو طفل لقيط، ولد نتيجة العدوان على الشعب الفلسطيني، واغتصاب أرضه. وأنه بعد مرور أكثر من قرن ونيف على التنقيب الأثري الذي لم يترك شبراً أو حجراً من أرض فلسطين دون قلبها، فإنه لم يعثر حتى الآن على أي دليل آثاري، سواء كان كتابة أو نقشاً، أو حتى نقش يقبل التفسير، أو في نصوص تقبل ـ حتى ـ التأويل، يمكن أن يشير إلى تاريخ «عبري/ إسرائيلي/ يهودي»؛ وأي محاولة للتوفيق بين البيِّنات التوراتيَّة، وغير التوراتيَّة، إثباتاً لتاريخانيَّة «العبري/ الإسرائيلي/ اليهودي»، سرعان ما دخلت مرحلة الانهيار، التي ما زالت مُتواصلة حتى اليوم.
ففي ندوة عقدتها جامعة بن غوريون عام 1998؛ كان موضوعها أصول «إسرائيل»؛ قال عالم الآثار «الإسرائيلي» فنكلشتاين، إن المصدر التوراتي الذي تحكَّم بماضي البحث في أصول «إسرائيل»، قد تراجعت أهميَّته، في الوقت الحاضِر، ولم يَعُدْ من المصادر الرئيسية المباشرة. فأسفار التوراة التي دُوِّنت، بعد وقت طويل من الأحداث، التي تتصدّى لروايتها، تحمِلُ طابعاً لاهوتياً، يجعلها مُنحازة؛ الأمر الذي يجعل من البحثِ عن بذورٍ تاريخيَّة، في المَروِيّات التوراتيَّة، عمليَّة بالغة الصعوبة؛ هذا إذا كانت ممكِنة من حيث الأصل. من هنا يرى فنكلشتاين، ضرورة استقراء الوقائع الأركيولوجيَّة، استقراءً موضوعياً، وحُراً، بمعزلِ عن الرواية التوراتيَّة.
من أبرز رُوّاد هذا الاتجاه، البروفيسور توماس طُمسن، أستاذ عِلم الآثار، في جامعة ماركويت، في ميلووكي بالولايات المتحدة الأميركية، الذي حورِبَ بسبب آرائه المعارضة، للتوراتيّين التقليديّين؛ فقد طُرِدَ من منصبِهِ، في عام 1992، لأنه دعا في كتابِهِ الذي صدر في العامِ نفسه، وعنوانه «التاريخ القديم للشعب الإسرائيلي»، إلى «نقض تاريخيَّة التوراة»، أي عدم الاعتماد على التوراة، كتاباً لتاريخِ المنطقة، والحضارات، وإلى اعتماد الحفريّات الأركيولوجيَّة (الأثريَّة)، وثروة الآثار الكِتابيَّة القديمة، كمصادر لإعادة كتابة تاريخ المنطقة، قائلاً: «إن أي محاولة لكتابةِ تاريخِ فلسطين، في أواخر الألف الثانية قبل الميلاد، أو بدايات الألف الأولى قبل الميلاد، في الضوء التام لمصادر الكتاب المقدَّس، لتبدو على الفورِ محاولة فاشلة، وميؤوس منها، بل يمكن اعتبارها محاولة هَزليَّة بالكامل، وتبعثُ على الضحكِ، والفكاهة. إن قصص العهد القديم، ما هي إلا مأثورات، وحكايات، كُتِبَتْ أثناء القرن الثاني قبل الميلاد. وإنه مَضيعة للوقتِ، أن يحاول أي إنسان أن يُثبِت مثل هذه الأحداث التوراتيَّة، من خلالِ عِلم الآثار القديمة؛ فالعهد القديم ليس له أي قيمة كمصدر تاريخي».
فقد قام العلّامة كيث وايتلام، أستاذ العلوم الكتابيَّة في قسمِ الدراسات اللاهوتيَّة، بجامعة سترلنغ، بالمملكة المتحدة، بمراجعةِ المؤلَّفات، التي تعاملت مع تاريخ فلسطين القديم؛ وأدرك في حينِهِ مدى توغُّل الخطاب الاستشراقي، في الكتابات عن تاريخ فلسطين. وأشار إلى أن هناك عملية طمس متعمَّد ومُبرمَج من قِبَلْ الحركة الصهيونية، لكثير من الدلالات التاريخية، للمكتشَفات الأثريَّة في فلسطين، ومحاولة تفسيرها بطريقة مغلوطة، في أغلب الأحيان. فتوصَّل في كتابِهِ «تلفيق إسرائيل التوراتيَّة طمس التاريخ الفلسطيني»، إلى أن «صورة ماضي إسرائيل، كما وردت في معظم فصول الكتاب العبري، ليست إلا قِصَّة خياليَّة، أي تلفيق للتاريخ».
أما الوجود التاريخي للشعب الفلسطيني، فالحفريات تشير إلى أن «الإنسان وجد في فلسطين منذ أقدم العصور، وأنه عاصر أقدم النماذج البشرية» ــ كما تفيد آخر المكتشفات الأثرية ــ منذ ما يربو على مليون ونصف مليون سنة خلت، وقد وجدت هياكله العظيمة وآثاره الحجرية في عدة مواقع من فلسطين، ويطول بنا المجال إذا ما حاولنا تتبع هذه المسيرة عقب الحقب السحيقة في القدم، فمن هنا ــ على ما يبدو ــ ظهر الإنسان العاقل، منذ ما يربو على خمسة وثلاثين ألف عام مضت، وقامت كل الثورات الأولى هنا، إن الثورة بدأت بتعلم الإنسان فنون الزراعة، حتى أصبح ينتج قوْتَه بعد أن كان يلتقطه، ويكفينا أن نقول إن الزراعة كانت أهم عامل دفع الإنسان نحو الحياة المستقرة؛ فنتج من ذلك ظهور المجتمعات الصغيرة الأولى، ثم تطورت هذه المجتمعات إلى قرى، ثم إلى مدن صغيرة وكبيرة. وقد رافق هذا تطور مهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والفنية والسياسية.
ما لم يقله أساف، أنّ الكيان الصهيوني هو طفل لقيط ولد نتيجة العدوان
فمن كان أصحاب هذه الحضارة، وإلى أي جنس ينتمون؟ أصحاب هذه الثورة الأولى، البالغة الأهمية، هم «الناطوفيون» (نسبةً إلى واد نطوف، شمال غرب القدس)، وتدل الهياكل العظمية التي عثر عليها في مواضع مختلفة على أن أصحاب هذه الثقافة كانوا أقرب إلى قصر القامة، يمتازون بالنحافة، يحملون صفات البحر المتوسط، برؤوسهم الطويلة، ووجوههم الضيقة المسكونة، مثل كثير من العرب الحاليين. فقد اكتشفت في فلسطين نحو خمسين هيكلاً لنموذج عرق البحر المتوسط في مقبرة قديمة، تبعد عشرين ميلاً عن القدس.
ويلمس المؤرخ في تاريخ فلسطين، منذ العصر الحجري الحديث، بعض الظواهر الحضارية الخاصة، التي تؤكد توافد سلالات بشرية من الصحراء إلى هذه المنطقة، لا شك في أنها سامية (بمفهوم لغوي).
في هذا الصدد، يقول البروفيسور توماس طمسن، إن هذا التغير في سوريا - فلسطين، أواخر العصر الحجري الحديث، وأوائل العصر النحاسي يجب ألا يعتبر غزواً كثيفاً، أو اقتلاعاً للسكان المحليين. إبان العصر الحجري الحديث كان الخليط الإثنى في فلسطين قد أصبح معقداً، ولا معلومات لدينا عن أية تطورات مهمة، خلال فترة الانتقال إلى العصر النحاسي. وأكثر من ذلك، إن وجود مستويات ثقافية ومادية لدى السكان المحليين، ووجود قرى ومدن ذات حجم كبير، ونظام اجتماعي تفوق أي شيء يمكن توقعه، يجعل من الصعب أن نتصور سوريا - فلسطين عرضة لغزو قام به عدد، لا بد أن يكون صغيراً، من الفلاحين والرعاة الساميين، والأحرى أنّ السكان المحليين استمروا، وأن التغير كان لغوياً وتدريجياً.
والقول إن الفلسطينيين يمثلون شعباً غريباً متطفلاً على فلسطين، يجب إنكاره، التأثير الوارد من بحر إيجه جزئي، وعلى أساس البينات المعروفة كان هامشياً، وسطحياً في اللغة، والديانة والأشياء المادية، حتى أقدم أشكال الفخاريات المدعوة فلسطينية - كانت ثقافة المنطقة الساحلية وطنية تماماً، يمكن القول إنها متأثرة بحضارة بحر إيجة ولكنها سامية تماماً، وذات طابع حضاري فلسطيني.
الحقيقة أن المخلفات الحضارية الفلسطينية في نهاية الألف الثاني قبل الميلاد ــ بما في ذلك الساحل الفلسطيني ــ تُعَدّ استمراراً لحضارة العصر البرونزي الأخير، ومن أهم المكتشفات التي تنسب عادة إلى الفلسطينيين فخار ملون، بأشكال هندسية، وطيور، وتظهر أيضاً أشكال حلزونية، ومجموعات من أنصاف دوائر متشابكة، إنما أشكال الأواني نفسها، فمشابهة للأواني التي عثر عليها في جزيرتي رودس وقبرص، لكنها غير مطابقة لها، ومن الصعب عدُّها مستوردة، بل على العكس، إن طينة الفخار محلية، وصانعوها أيضاً، رغم تأثرهم بصناعة الفخار المعروفة في الجزر الإيجية، وظهرت التأثيرات الكنعانية المحلية على مخلفات الفلسطينيين من خلال أسماء آلهتهم أمثال داجون وعشتروت، كذلك إن العمارة من مبانٍ عامة، ومنازل، مستمدة من التقليد المعماري للعصرين البرونزي الوسيط، والأخير، والحياة الدينية عند سكان الساحل الفلسطيني كنعانية الأصل، وكذلك المباني الدينية، وأهمها سلسلة المعابد المتعاقبة في تل القصيلة، التي أنشئت على غرار المعابد الكنعانية، مع ما يظهر عليها من تأثيرات مصرية وإيجية.
بذلك يصعب على الباحث التفريق بين ما يمكن نسبته إلى المجموعات البشرية التي سكنت فلسطين في أواخر الألف الثاني قبل الميلاد، فوجود هذا الصنف من الفخار، أو ذلك في منطقة معينة، لا يدل بالضرورة على سكنى هذه المنطقة من مجموعة إثنية مختلفة، ولكنها غالباً ما تعني أن هذه المنطقة وقعت تحت تأثيرات خارجية.
فبالنظر إلى أن السكان الأصليين لم يتغيروا كثيراً منذ العصر الحجري، وخلال فترة الألف السادس - الرابع قبل الميلاد، أصبحت فلسطين سامية (بمفهوم لغوي)، وخلال العصر البرونزي القديم، أقامت نمطاً استيطانياً واقتصادياً بقي من خصائص المنطقة حتى الحقبة الآشورية في الأقل.
بذلك، فالسمة الأهلية للسكان لم تعد موضع تساؤل الآن، وهذه السمة تظهر بوضوح في جذور الثقافة المادية في العصر البرونزي القديم، والظاهرة في الأواني، والأدوات، والبناء، وطقوس الدفن، وأنماط الاستيطان.
إذاً، الفلسطينيون مزيج عرقي له نواة قوية عريقة في القدم، وقد كان أجداد اللاجئين العرب الفلسطينيين الذين يحيون اليوم في الغربة حياة بائسة، يحرثون الحقول في فلسطين، قبل ثلاثة آلاف عام، ويبدو أنه مما يتصل بذلك، أن اللاجئين الفلسطينيين يكنون لوطنهم حباً لا يمكن تصوره أبداً، إنهم يثيرون انطباعاً مؤداه أنهم شعب يضرب بجذوره في الأرض، متعلقاً بكل بيت ريفي صغير، وبكل شجرة برتقال، وبكل حجر، فليس الفلسطينيون رعاة لا يعنيهم كثيراً أن يستقروا هنا تارة، وهناك تارة أخرى، ومع ذلك فأكثر العرب يكتفون في النزاع الفلسطيني بالإشارة إلى التراث التاريخي العربي - الإسلامي الذي دام ألفاً وثلاثمئة عام، وعلى أية حال فقد عُرِّبَت فلسطين في وقت كانت فيه هجرات الشعوب تجري على قدم وساق، ولم تكشف أميركا إلا بعد ذلك بـ580 عاماً.
فيا له من حق من حقوق الملكية هذا الذي يجدّ المؤرخون الصهاينة اليوم سعياً وراء تحطيمه! حق احتفظ به بطريق بسيط دؤوب، منذ خرج الإنسان من غياهب المجهول، وربما كان أبسط، وأوضح حق من حقوق الملكية في العالم.
صحيفة الأخبار اللبنانية
أضيف بتاريخ :2017/07/03