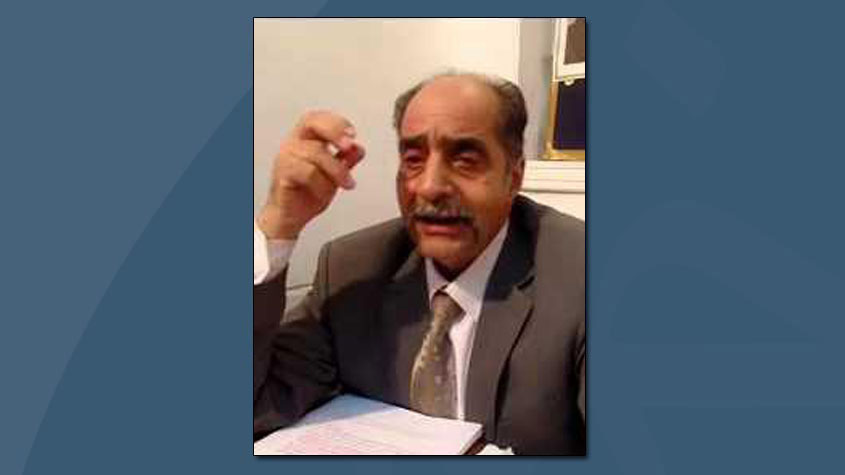المسار «اللولبي» للإمبريالية الأميركية: دورةٌ للتهدئة... وأخرى للحرب
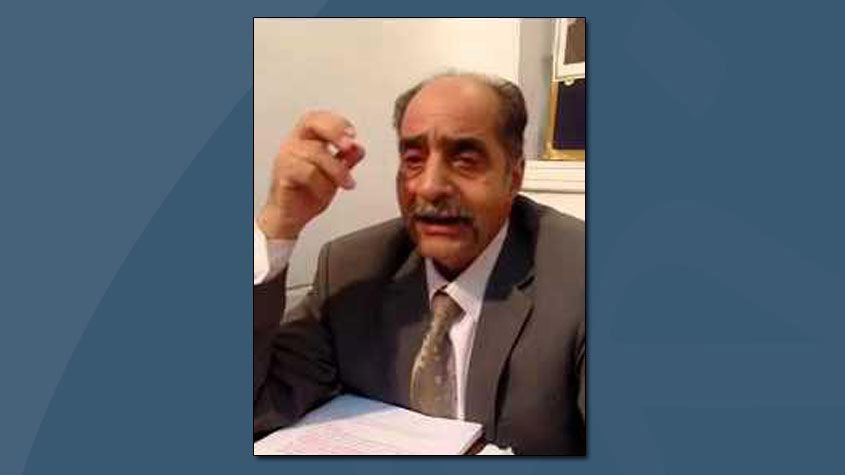
محمد عبد الشفيع عيسى
تعتبر نظرية «الاستعمار» (Colonialism)، من بين أهم النظريات المفسرة للعلاقات الدولية فى العصر الحديث، حتى إن لم تكن «نظرية» بالمعنى الفلسفي الدقيق، وإنما بالأحرى «نظرة» توجيهية أو اتجاهاً نظرياً نافذاً، ومنها نبعت نظريات متعددة، ربما أشهرها نظرية «الإمبريالية»، التي بلورها لينين في كتابه الشهير «الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية». ولمّا كان لينين قد استند فى بلورة نظريته عن الإمبريالية إلى مفهوم «رأس المال المالي»، وخاصة عند «هل فيردنغ»، ومفهوم «الإمبريالية» عند «هوبسون»، فقد حق لآخرين لاحقين، أن يتتبعوا تطور الرأسمالية، ليظهر التوجه نحو «ما بعد الاستعمار»، ومفهوم «المركز والمحيط»، وكذلك «نظرية التبعية» وغيرها.
ويمكن التعبير عن التوجه الأساسي «للنظرية الأم» حول الاستعمار، في أن تفاوت مستويات التطور داخل المنظومة العالمية الرأسمالية، يولد نزوعاً متأصلاً إلى الهيمنة أو السيطرة من قبل القوى الأكثر تقدماً تجاه القوى والبلدان الأدنى تطوراً، من حيث مستوى التقدم الاقتصادي والتكنولوجي ومن حيث طبيعة هياكل الإنتاج. تلك الهيمنة تختلف أشكالها، لكنها عموماً تتمثل في السيطرة التامة لبعض الدول الرأسمالية المتقدمة على مناطق وبلدان اعتبرت من وجهة نظر المقارنة التاريخية: متأخرة، فمتخلفة، ثم «نامية»، وتقع في القارات الثلاث لأفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. وقد تغيرت مواقع الدول الممارسة للاستعمار والسياسة الاستعمارية عبر العصر الحديث: فقد بدأ الأمر في إسبانيا (وإلى حد ما البرتغال) في القرنين السادس عشر والسابع عشر، لتصل إلى الذروة في القرن الثامن عشر، ويتجلى انحدارها مع حروب الاستقلال لبلدان أميركا الجنوبية والوسطى، في الربع الأول من القرن التاسع عشر، ثم الحرب الإسبانية ــــ الأميركية في عام 1898، وهولندا (وخاصة في شبه القارة الهندية، وجنوب شرق آسيا، فيما يمثل إندونيسيا الآن وغيرهما)، وإلى حد ما بلجيكا، (كما في القارة الأفريقية ــــ حوض نهر الكونغو). ثم انتقل زمام قيادة تيار الهيمنة الاستعمارية بصورة تدريجية إلى الثنائي بريطانيا وفرنسا، خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، مع منازعة نسبية من طرف ألمانيا، بعد عام 1870، ولا سيما عبر مؤتمر برلين في عام 1884، والذي قسم مناطق السيطرة الاستعمارية، إلى حين، ودشّن ما يُسمى بالتكالب نحو أفريقيا. وكان أن بزغ نجم الولايات المتحدة الأميركية رويداً خلال القرن العشرين، لتتولى، في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية (1945)، مهمة قيادة المنظومة العالمية للرأسمالية باتجاه الهيمنة. وفي المقابل، كان هناك الاتحاد السوفياتي، الذي يستحق تتبع نهجه في العمل الداخلي والتعامل الدولي معالجة خاصة في مقام آخر.
ويلاحظ في ما يتعلق بنظام الهيمنة الأميركي، أو الإمبريالية في نسختها الأميركية، أن السياسة «الاستعمارية» الأميركية، ينطبق عليها، بمعنى معين، مفهوم الدورات التعاقبية، يجمع بينها استخدام القوة في العلاقات الدولية، كسبيل رئيسي لتحقيق أهداف السياسة الخارجية. وبيان ذلك، أنه تكون هناك دورة تستخدم فيها القوة المسلحة (بدرجة أو بأخرى) على أوسع نطاق ممكن، في ما يعرف بالحرب، ضمن سياق «الحروب المحدودة»، خلال حقبة «الحرب الباردة» 1945 - 1991. تلي ذلك دورة أخرى للتهدئة، مختلفة عما سبق، وتستخدم فيها الأشكال المتنوعة للقوة تطبيقاً لنظرية التهديد والردع، بما في ذلك «القوة المجسدة»، وربما «المسلحة»، في نطاقات ضيقة نسبياً، في ما يُعرف بالتدخل العسكري المحدود. وغالباً ما كانت «دورة التهدئة» من نصيب «الحزب الديموقراطي»، و«دورة الحرب» من نصيب «الحزب الجمهوري».
في الدورة الأولى، ذات الاستخدام الموسع للقوة المسلحة، يكون شن الحرب ــــ من دون إعلان رسمي غالباً ــــ الخيار الأبرز؛ حرب يسقط فيها الضحايا إلى حدود قد لا تصل فيها الأعداد المعدودة إلى الآحاد أو العشرات المفردة فقط، أو المئات، بل إلى الآلاف، وربما عشرات الآلاف أو مئات الآلاف، بين قتيل وجريح، في هذه القارة أو تلك من بين القارات الثلاث (أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية). أما في الدورة الثانية ــــ «دورة التهدئة النسبية» ــــ فتكون أشكال التدخل المتنوعة أكثر ظهوراً، من دون استبعاد وقوع تدخلات عسكرية انتقائية، أو ضربات موجعة محدودة المدى الزمني والنطاق المكاني، ولكن بغير انخراط فى «حرب»، بالمعنى التقني الشائع، سواء بمعيار اتساع الرقعة الميدانية للقتال، أو الاستمرارية الزمنية، وكثافة العمليات، وأعداد الضحايا المحتملين، بين مقتول ومصاب.
فكرة «الدورات في السياسة الأميركية هذه، كان قد تنبّه إليها الدكتور فؤاد زكريا منذ مدة، وقد وجدنا فيها فائدة تحليلية ثمينة، حيث تقترب من الواقع إلى حد كبير. وتطبيقاً لفكرة الدورات هذه، تنزيلاً على الفترات الرئاسية الأميركية بعد الحرب العالمية الثانية، يمكن أن نجد ما يلي، على سبيل المثال:
فقد تولى الرئيس هاري ترومان (2 نيسان/ أبريل 1945 ــ 20 كانون الثاني/ يناير 1953) مهمة إسقاط القنبلة الذرية على هيروشيما وناكازاكي في اليابان في عام 1945 عند نهايات الحرب، رغم إعلان اليابان الاستسلام، أعقبه دوايت أيزنهاور (20 كانون الثاني/ يناير 1953 ــ 20 كانون الثاني/ يناير 1961)، الذي وقف ضد العدوان الثلاثي (البريطاني الفرنسي الإسرائيلي) على مصر في عام 1956، تدشيناً لعصر القوة الأميركية البازغة، وإيذاناً بغروب عصر الهيمنة البريطانية ــــ الفرنسية، أو ما يُسمى الاستعمار التقليدي أو القديم، وذلك في ظل ما يُسمّى «مبدأ أيزنهاور» وتطبيقاته الإقليمية، وفي مقدمتها (ملء الفراغ في الشرق الأوسط).
في أواخر عهد «أيزنهاور»، بدأ التدخل العسكري الأميركي في فيتنام (1959)، لتستمر الحرب (حرب فيتنام) بعد ذلك أربع عشرة سنة، حيث بدأت هيّنة متدرجة غير معلومة آفاقها، في ظل ولاية الرئيس جون كيندي (20 كانون الثاني/ يناير 1961 ــ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1963)، ثم تصاعدت في ظل ليندون جونسون، الذي تولى الحكم مع اغتيال كيندي حتى 22 كانون الثاني/ يناير 1969. وخلال ولايته، انتهت فترة التهدئة النسبية لأيزنهاور وكيندي، وأطلّ استخدام القوة المسلحة بأقصى أشكالها، وخاصة من خلال التصعيد المصاحب لحرب فيتنام، وكذا مساندة إسرائيل، بأشكال مباشرة وغير مباشرة، في عدوان حزيران/ يونيو عام 1967 على مصر وسوريا والأردن.
أتت فترة نيكسون (20 كانون الثاني/ يناير 1969 ــ 9 آب/ أغسطس 1974) لتمثل فترة تهدئة، نسبيّاً، من خلال تطبيق ما سمّي «مبدأ نيكسون» في الاعتماد على الحلفاء والشركاء الإقليميين، بدلاً من التدخل المباشر، مع المضي في تطوير سياسة «الوفاق» وبالأحرى (الانفراج) مع كل من الاتحاد السوفياتي والصين، والعمل على إبرام تسوية سياسية لحرب فيتنام، وبدء انسحاب القوات الأميركية، وإعلان وقف إطلاق النار في عام 1973.
بعد إجبار نيكسون على الاستقالة في الـ 9 من آب/ أغسطس عام 1974، إثر ما سُمى فضيحة «ووترغيت»، استكمل مدة ولايته الرئاسية الثانية، جيرالد فورد (9 آب/ أغسطس 1974 ــ 20 كانون الثاني/ يناير 1977) لعامين ونصف عام تقريباً. ومن بعده جاء جيمى كارتر (20 كانون الثاني/ يناير 1977 ــ 20 كانون الثاني/ يناير 1981)، ليمضي قدماً في مسار التهدئة، في محاولة لتضميد جراح حرب فيتنام الخشنة والناعمة، وكانت وساطته بين أنور السادات وإسرائيل عبر مسار «كامب ديفيد» (1978 ــ 1979)، حتى عقد المعاهدة بين حكومتَيْ مصر وإسرائيل. ولم يمنع مسار التهدئة من تجريب «التدخل العسكرى المحدود»، في محاولة للإفراج عن الرهائن من أسرى السفارة الأميركية في طهران، إثر قيام الثورة الإيرانية بقيادة «الخميني» في عام 1979.
ومن بعد كارتر، يجىء رونالد ريغان (20 كانون الثاني/ يناير 1981 ــ 20 كانون الثاني/ يناير 1989)، محمولاً على أجنحة الصقور من (المحافظين الجدد) خلال عقد الثمانينيات، حيث اتبع سياسة التهديد حتى حافة الهاوية، عبر التدخل في كل من «غرينادا» و«بنما» من (جمهوريات الموز) التابعة تقليدياً للولايات المتحدة في أميركا الوسطى. وكذا وقع التدخل بالأسطول الأميركي السادس على سواحل بيروت، إبان الحرب الأهلية اللبنانية، حتى تم تفجير مقر مشاة البحرية، ومقتل زهاء 300 جندي أميركي وفرنسي ( 23 تشرين الأول/ أكتوبر 1983). ولا ننسى التلاعب بمتغيرات الحرب العراقية/ الإيرانية من عام 1981 إلى عام 1988. أما أبرز «نجاحات» ريغان التدميرية، فهي تصعيد سباق التسلح مع الاتحاد السوفياتي إلى ما سُمي التأهب «لحرب النجوم»، إلى جانب منظومة مواجهات ساخنة (غير باردة يعنى ...!) ضد الاتحاد السوفياتي في معقل شركائه أو حلفائه في أوروبا الشرقية (الاشتراكية)، حتى تم انهيار الاتحاد السوفياتي نفسه، بعد انتهاء ولايته بقليل في مطالع 1991. كان ذلك في ظل الولاية البادئة لجورج بوش (الأب) (20 كانون الثاني/ يناير 1989 ــ 20 كانون الثاني/ يناير 1993)، الذي ما إن استكمل معركة إسقاط الاتحاد السوفي تي، حتى قام إثر ذلك (أو أثناءه)، بشّن ما سُمي «حرب تحرير الكويت» مطلع عام 1991. وأعقبت (الكويت) محاولة ــــ فاشلة نهاية الأمر ــــ لتهدئة السطح الملتهب لمضاعفات القضية الفلسطينية، من خلال عقد مؤتمر مدريد في سبتمبر عام 1991، وما صاحبه من دعوة زاعقة نحو «الشرق أوسطية»، وخاصة من خلال ما سمي مؤتمرات القمة الاقتصادية بين العرب وإسرائيل، حيث عقدت سلسلة من المؤتمرات حول ما سمّي «التعاون الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وانعقد المؤتمر الأول في الدار البيضاء ــــ المغرب ــــ في عام 1994، والثاني في عمّان ــــ الأردن في عام 1995، ثم الثالث في القاهرة، في تشرين الأول/ أكتوبر عام 1996.
تحت شعار «إنه الاقتصاد يا غبيّ»، هُزم جورج بوش (الأب) في الانتخابات الرئاسية، ليعقبه الرئيس بيل كلينتون، (مع نائبه والتر مانديل)، متولياً دورتين رئاسيتين (20 كانون الثاني/ يناير 1993 ــ 20 كانون الثاني/ يناير 2001)، وكانت هذه عموماً فترة التهدئة الأميركية، للتركيز على الداخل الاقتصادي ــــ التكنولوجي، سعياً إلى تطوير حمّى التنافس إلى حدّ إسقاط تحدي المنافسين الكبار فى كل من اليابان وأوروبا، ومن ثم تربع الولايات المتحدة على عرش التكنولوجيا العالمية (هاي تلك)، في مجالات متعددة، من «المواد الجديدة»، إلى «الطاقة الجديدة المتجددة»، وفي القلب «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، وصولاً إلى التكنولوجيا الحيوية، إلى حد تحقيق اختراقات مهمة قي مشروع «الخريطة الوراثية» ــــ الجينوم البشري ــــ في عام 2000، كمشروع رئيسي بدأ في عام 1980، واستكمل في عام 2003.
لقد مهدت التهدئة الكبرى والفعالة تنافسياً من الجانب الأميركي إلى تنصيب «جورج دبليو بوش» (بوش الإبن) (20 كانون الثاني/ يناير 2001 ــ 20 كانون الثاني/ يناير 2009)، ليكون ملكاً متوجاً للعنف والعنف المتطرف بالذات، تجاه الأعداء، بل والأغيار عموماً، أو بعضهم «ومن ليس معنا فهو ضدنا!». وكانت حادثة تفجير مركز التجارة العالمي في واشنطن (11 أيلول/ سبتمبر عام 2001)، مناسبة لانطلاق «المحافظين الجدد المجانين» (New Conservatives Crazy) نحو تطبيق نظرية شن «حربين في وقت واحد». وكان ما كان من شن حرب أفغانستان في (كانون الأول/ ديسمبر عام 2001)، التي ظلت نيرانها مشتعلة حتى الآن (!..)، ثم «حرب» غزو العراق (آذار/ مارس ــــ نيسان/ إبريل عام 2003)، التي لا تزال معقباتها ماثلة حتى اللحظة.
وكان لا بد من التهدئة بعد الغليان، ليجىء الرئيس باراك أوباما (20 كانون الثاني/ يناير 2009 ــ 20 كانون الثاني/ يناير 2017)، ساعياً إلى خفض موجة التوتر، ويبدأ مساراً للانسحاب من أفغانستان والعراق، تحت مظلة السعي إلى نقل محور التركيز إلى شرق آسيا، في محاولة لخفض التوترات الخارجية إلى أكبر حد ممكن. وفي ظل سياسة التهدئة التي انتهجتها إدارة أوباما، وقعت سلسلة من الأحداث السياسية التي كان لدبلوماسية التوافق ــــ في إطار الأمم المتحدة ــــ دور كبير في إنجازها، وخاصة عقد «اتفاقية باريس» حول المناخ، بواسطة آلية «التراضي العام» ــــ من دون تصويت ــــ (21 كانون الأول/ ديسمبر عام 2015)، وما سُمّي الصفقة النووية مع إيران، بالاتفاق مع القوى الدولية الفاعلة (5+1) «خطة العمل المشتركة الشاملة في تموز/ يوليو عام 2015)، بالإضافة إلى الانضمام إلى «اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ» (15 آذار/ مارس 2013)، والسعى إلى اتفاق شراكة مع أوروبا (عبر الأطلنطي).
تطبيقاً لنظرية الدورات في المسار اللولبي للإمبريالية الأميركية، كان لا بد من أن يتلو مسار التهدئة مسار للتصعيد بالعنف حتى حافة الهاوية، نحو «حروب» متعددة الأشكال. هذه هي المهمة التي وقعت على عاتق دونالد ترامب، الذي تولى الرئاسة اعتباراً من 20 كانون الثاني/ يناير عام 2017، ليمارس تطبيق «المهمة المقدسة»: أميركا أولاً (America First)، (في الحقيقة: «أميركا البيضاء أولاً» على حد تعبير البعض). وكان لا بد لدونالد ترامب من تدشين عصر العنف ــــ غير المجسد عسكرياً بالضرورة ــــ من خلال إسقاط رموز التهدئة (الأوبامية)، وخاصة اتفاقية باريس للمناخ، والصفقة النووية الإيرانية، واتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ. ثم كان التهيؤ لخوض نوع من «الحرب التجارية» مع الحلفاء والشركاء، وخاصة الصين وأوروبا وروسيا، وكل من تقع عليه عيناه من وجهة نظر التهديد المحتمل لمكانة الولايات المتحدة في مقدمة الصفوف أو أعلاها.
يجىء دونالد ترامب محمولاً على أعناق نزعة ذات طابع عنصري (أبيض)، يقال لها (شعبوية)، موجهة نحو الخارج، لاستبدال سياسة التعاون المتكافئ نسبياً مع الشركاء والحلفاء، ولو من خلال التنازلات المتبادلة، بسياسة ذات طابع هجومي مستهدفة غايات استراتيجية، أبرزها تثبيت المكانة الأميركية، حيث هي بالذات في الأمام وإلى الأعلى، وتحقيق أكبر منافع اقتصادية ممكنة، وعلى الأقل: الحد من نزف الخسائر التي كانت تتحملها أميركا (راضية) لعشرات السنين، مقابل إنفاذ سياسات الهيمنة. وكانت تتحقق فوائد اقتصادية جمة من وراء إنفاذ سياسات الهيمنة بوسائل عدة، من بينها، تسهيل فرض هيمنة الدولار على عرش العملات العالمية، كأداة لتسوية المبادلات الدولية ووسيط للمعاملات وكمخزن للقيمة، في نوع من «الإمبريالية النقدية» وفق تعبير البعض. يضاف إليه، جني الأرباح الاحتكارية القصوى للشركات الأميركية عابرة الجنسيات، من تسويق التكنولوجيا المتقدمة؛ بالإضافة إلى المساعدة على فرض أسعار «غير عادلة» للنفط والمواد الأولية، والارتكاز إلى الوجود العسكري عند منابع النفط، وفي مناطق النزاعات.
في الجوهر خلف هذا كله، إدراك شرائح النخبة الأميركية الموالية لسياسات دونالد ترامب، لخطورة تسارع مسيرة اضمحلال القوة الأميركية عبر الزمن، وإن استشعار هذه الحقيقة التاريخية بحساسية زائدة، يدفع هذه الشرائح (الترامبية)، إن صح التعبير، إلى العمل بكل الوسائل المتاحة من أجل منع التدهور، أو تأجيله لأطول فترة ممكنة على الأقل؛ ولن يكون ذلك بغير اتباع الحكمة التقليدية (الهجوم خير وسائل الدفاع). من هنا، ينبع أصل محاولات الحرب التجارية، وحروب أخرى (غير ساخنة بالضرورة)، مثل ما يظهر من معاودة التسلح الفضائي. وغير بعيد من ذلك، تشديد الاعتماد على التوابع الموثوقين من أضراب إسرائيل وتايوان. ويدخل في هذا، العمل من أجل تصفية القضية الفلسطينية، كي تفرغ إسرائيل لـ«المهمة المقدسة» في نطاقها الإقليمي: المساعدة على تثبيت المكانة الأميركية، أو تأجيل تدهورها، ضمن علاقة تحالفية فريدة بين «الإمبريالية الكبرى» (أميركا) و«الإمبريالية الصغرى» (إسرائيل).
دولة أم دولتان... ؟
قد نزعم في ضوء تحليلنا السابق، أن في أميركا دولة واحدة لا دولتين، أو أن النظام السياسي الأميركي يحمل في طياته شريحتين متواكبتين، غير متناقضتين جوهرياً، من النخبة السياسية المسيطرة. وقد يرى البعض، على عكس ذلك، أن ثمة دولة مستترة للأمن القومي أو «حكومة خفية»، ودولة أخرى طافية على السطح أو «حكومة ظاهرة»، وأن الدولة الموازية المتخفية قد تتطابق حيناً مع نظام الحكم أو «الإدارة»، ولو بصفة نسبية، فيحدث التوافق بين الجانبين، كما حدث في عهد «أوباما» مثلاً، وقد تتفارق أو تنازع «الإدارة» حيناً آخر، كما يحدث الآن في إدارة «ترامب». لكننا، على خلاف هذا، نزعم أنها دولة واحدة غير أنها بوجهين: تُظهر وجهاً أول في لحظة تاريخية معينة، بينما تخفي الوجه الثاني مؤقتاً، لتظهره في لحظة تاريخية أخرى، متلونة هكذا، حسب مقتضيات الظرف الداخلي والخارجي في آنٍ معاً.
وهكذا، فإن ما قد يبدو أنها دولة للأمن القومي الأميركي كامنة خلف إدارة ترامب الراهنة، مترصدة لها، و«تقلب لها ظهر المجنّ»، إن جدّ الجدّ، هي، فيما نرى، ليست في الحقيقة منفصلة ــــ بما هي كذلك ــــ عن الإدارة أو تناصبها العداوة بالضرورة، وإنما تغير لهجتها أو جلدها ولونها الظاهر فقط. والهدف الثابت، أن تتكاتف فعلياً الشريحة الطافية على السطح، من النخبة الحاكمة مع الشريحة «الغاطسة»؛ ومن تكافلهما وتكاملهما الجدلي دوماً، وإن اختلفا قليلاً أو كثيراً، تتحقق المحافظة على (استقامة) العقل الاستراتيجي الإمبريالي للولايات المتحدة الأميركية باتجاه الهيمنة على الصعيد العالمي؛ كما تتحقق وحدة «النظام السياسي الأميركي» وقدرته على البقاء، إلى حين.
صحيفة الأخبار اللبنانية
أضيف بتاريخ :2018/10/05