أهداف أميركية مستمرة دون تورّط عسكري كبير
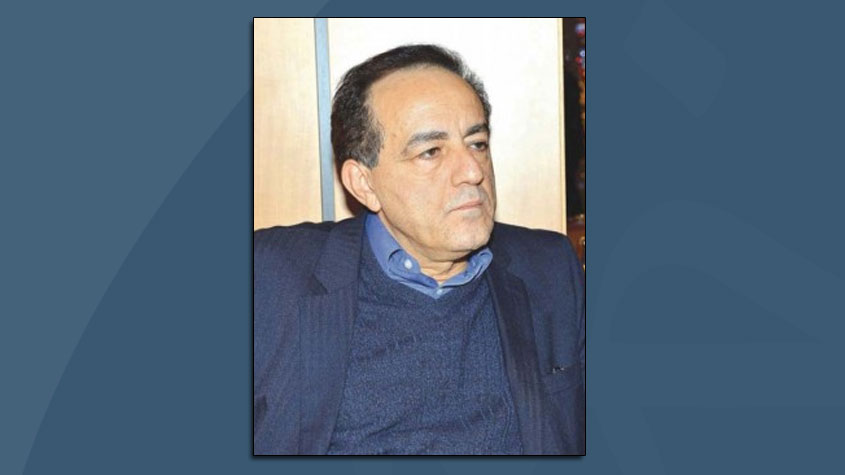
د. صبحي غندور
تميّزَ انتهاء الحقبة الأوروبية الاستعمارية، التي امتدّت إلى منتصف القرن العشرين، بأنّ الاستعمار الأوروبي كان يُخلي البلدان التي كانت تخضع لهيمنته، في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، بعد أن يوجِد فيها عناصر صراعات تسمح له بالتدخّل مستقبلاً، وتضمن إضعاف هذه البلدان التي قاومت الاستعمار وتحرّرت منه. فقد ظهرت دول وحكومات خلال القرن الماضي إمّا تتصارع فيما بينها على الحدود، أو في داخلها على الحكم بين “أقليّات” و”أكثريّات”، وفي الحالتين، تضطرّ هذه الدول النامية الحديثة للاستعانة مجدّداً بالقوى الغربية لحلّ مشاكلها أو لدعم طرفٍ داخلي ضدّ طرفٍ آخر. وجدنا ذلك يحدث في الهند مثلاً، التي منها خرجت باكستان، ثمّ تصارعت الدولتان على الحدود في كشمير. ووجدنا ذلك يحدث أيضاً في صراعات الحدود بين عدّة دولٍ عربية وإفريقية. كما حصلت عدّة حروب أهلية وأزمات أمنية وسياسية في بلدانٍ أخلاها المستعمر الأوروبي بعد أن فرض فيها أنظمة حكم مضمونة الولاء له، لكنّها لا تُعبّر عن شعوبها، وتُمثّل حالةً طائفية أو إثنية فئوية لا ترضى عنها غالبية الشعب.
متغيّراتٌ دولية كثيرة حدثت بعد الحرب العالمية الثانية، وخلال العقود الماضية التي تبعت انتهاء الحقبة الأوروبية الاستعمارية، ومنها وراثة الولايات المتحدة للإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية وظهور معسكريْ “الشرق الشيوعي” بقيادة روسيا، و”الغرب الرأسمالي” بزعامة أميركا. لكن انتهاء “الحرب الباردة” بين المعسكرين، مع غروب القرن العشرين، لم تكن نهايةً لنهج التنافس الدولي على العالم وثرواته ومواقعه الجغرافية الهامّة، كما هو موقع الأمَّة العربية وثرواتها الهائلة.
الحرب على أفغانستان في نهاية العام 2001 ثمّ الحرب على العراق في مطلع العام 2003، وما رافق هاتين الحربين من انتشار عسكري أميركي في محيط دول الشرق الأوسط، وإقامة قواعد في بعضها، في إطار التوظيف الكبير لأعمال الإرهاب التي حدثت ضدّ أميركا، من أجل تبرير حروبٍ وسياسات ما كان لها أن تحدث لولا “خدمات” جماعات “القاعدة” و”داعش” وأخواتهما، ذلك كلّه كان وما يزال أعمالاً عسكرية من أجل خدمة رؤية سياسية لها مضامين أمنية واقتصادية.
ولأنّ التواجد العسكري الأميركي في المنطقة لا يكفي وحده من أجل ضمان المصالح الأميركية في “الشرق الأوسط الأوسط الكبير”، فإنّ عناصر ثلاثة يتوجّب توفّرها بشكلٍ متلازم مع الوجودين العسكري والأمني:
1- السعي لجعل منظومة الحكم في معظم دول المنطقة مبنيّةً على مزيج من آليات ديمقراطية وفيدراليات إثنية أو طائفية. فالديمقراطية، لو تحقّقت، دون التركيبة الفيدرالية (التي ستكون حصيلة تعزيز المشاعر الانقسامية في المجتمع الواحد)، يمكن أن توجِد أنظمة وحكومات تختلف مع الرؤية الأميركية.
أيضاً، فإنّ إثارة الانقسامات الإثنية أو الطائفية، دون توافر سياق ديمقراطي ضابط لها في إطار من الصيغة الفيدرالية، يمكن أن يجعلها سبب صراعٍ مستمرّ يمنع الاستقرار السياسي والاقتصادي المنشود بالرؤية الأميركية، ويجعل القوات الأميركية المتواجدة بالمنطقة عرضةً للخطر الأمني المستمرّ في ظلّ حروبٍ أهلية مفتوحة. إضافةً إلى أنّ التركيبة الفيدرالية القائمة على آليات ديمقراطية ستسمح للولايات المتحدة بالتدخّل الدائم مع القطاعات المختلفة في داخل كلّ جزءٍ من ناحية، وبين الأجزاء المتّحدة فيدرالياً من ناحية أخرى.
2- التركيز على هويّة “شرق أوسطية” كإطار جامع للفيدراليات المتعدّدة المنشودة في بلدان المنطقة العربية، إذ أنّ العمل تحت مظلّة “الهُوية العربية” يمكن أن يؤدّي مستقبلاً إلى ما ليس مرغوباً به أميركياً من نشوء تكتّلات كبرى متجانسة ذات مضامين ثقافية متباينة مع الرؤية الأميركية، كما حدث ويحدث في تجربة الاتحاد الأوروبي، رغم وجود القواعد العسكرية الأميركية في أوروبا، ورغم وجود حلف الأطلسي والانتماء المشترك لحضارة غربية واحدة.
لهذا يدخل العامل الإسرائيلي كعنصر مهمّ في الشرق الأوسط الكبير المنشود أميركياً منذ ثلاثة عقود من الزمن، إذ بحضوره الفاعل، تغيب الهويّتان العربية والإسلامية عن أيِّ تكتّل إقليمي محدود أو شامل.
3- العنصر الثالث المهمّ، في الرؤية الأميركية المستقبلية للشرق الأوسط، يقوم على ضرورة إنهاء الصراع العربي/الإسرائيلي من خلال إعطاء الأولوية لتطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل، وقبل تحقيق التسوية الشاملة التي تتطلّب حسب المنظور الأميركي سنواتٍ عديدة. وتجد الإدارة الأميركية الآن فرصةً مهمّة لتطبيع العلاقات العربية – الإسرائيلية ممّا سيدفع الأطراف العربية، والطرف الفلسطيني تحديداً، إلى والقبول بحدود دنيا من المطالب والشروط، كما قد يساعد أيضاً على تحجيم نفوذ خصوم أميركا في المنطقة.
***
بعد احتلال العراق في العام 2003، أطلقت إدارة بوش الابن ثلاثة شعارات، فشل منها اثنان وبقي الشعار الثالث رهناً بما يحدث الآن من صراعات ومتغيّرات عربية.
الشعار الأول كان عقب غزو العراق مباشرةً حينما تحدّث أكثر من مسؤول أميركي عن أنّ العراق سيكون “نموذجاً للديمقراطية” في الشرق الأوسط، وأنّ دولاً عديدة في المنطقة ستحذو حذوه. الشعار الثاني، كان عن “الشرق الأوسط الكبير” الجديد الذي سيخرج إلى الوجود بعد تفاعلات الحرب في العراق، وبعد حروب إسرائيل في لبنان وغزّة في عام 2006 والتي دعمتّها بشدّة إدارة بوش الابن.
سقط حكم “المحافظين الجدد” في أميركا في انتخابات العام 2008، وسقطت معهم أحلام “الإمبراطورية الواحدة في العالم”، وأصبحت التجربة الأميركية في العراق “نموذجاً” للفشل والكذب والخداع في السياسة الأميركية، ولم تتدحرج أنظمة المنطقة خلف “الدومينو العراقي”، كما توهَّم وراهن “المحافظون الجدد”، وكذلك كان مصير المراهنات في القضاء على ظواهر المقاومة ضدّ إسرائيل بعد حربيْ صيف عام 2006 في لبنان ونهاية عام 2008 في غزّة.
أمّا الشعار الثالث، الذي أطلقته الوزيرة كونداليزا رايس خلال الفترة الثانية من حكم بوش الابن، فكان عن “الفوضى الخلّاقة” والتي كانت المراهنة على حدوثها في بلدان الشرق الأوسط من خلال تفاعلات الأزمات الداخلية في دول المنطقة. ولعلّ ما حدث ويحدث في السنوات الماضية داخل عدّة بلدانٍ عربية يؤكّد أنّ شعار “الفوضى الخلّاقة” لم ينتهِ مع نهاية حكم “المحافظين الجدد”، وبأنّ المراهنات ما زالت قائمة على هذا الشعار، رغم التغييرات التي حدثت في “البيت الأبيض” في فترة حكم الرئيس باراك أوباما، بل ازداد العمل لتنفيذ هذا السياسة خلال إدارة ترامب وتبنّيها الكامل لأجندة نتنياهو في مختلف قضايا منطقة “الشرق الأوسط”.
الوقائع والتجارب كلّها تؤكّد وجود أهداف ومصالح ومؤسسات أميركية، محصّنة ضدّ تأثيرات ما يحدث في الحياة السياسية الأميركية من تحوّلات وصراعات انتخابية محلّية.
ولم يكن ممكناً طبعاً فصل ملف تاريخ الأزمة الأميركية مع إيران عن ملفّات “الأزمات الأخرى” في المنطقة العربية، وعن حلفاء طهران في سوريا والعراق ولبنان واليمن وفلسطين. فإيران معنيّة بشكلٍ مباشر أو غير مباشر في تداعيات أيّ صراع، حدث أو قد يحدث، فيما هو قائمٌ الآن من أزماتٍ عربية. ومن رحم هذه الأزمات على الأراضي العربية توالدت مخاوف سياسية وأمنية عديدة، أبرزها كان وما يزال من مخاطر الصراعات الطائفية والمذهبية والإثنية، خاصّةً في ظلّ امتداد دور ووجود الجماعات الإرهابية، وما رافق ذلك الصراع مع الإرهاب من عنفٍ مسلّح وصراعات وتنافس على الحكم وعلى المعارضة.
والمحصّلة من ذلك كلّه، أنّ صُنّاع القرار الأميركي يأملون الآن كثيراً في تحقيق أهداف السياسة الأميركية في “الشرق الأوسط”، من خلال تفاعلات الصراعات المحلّية والإقليمية الدائرة بالمنطقة، ودون حاجةٍ لتورّطٍ عسكريٍّ أميركي كبير في أيٍّ من بلدانها!.
وكان الانهيار يحدث عربياً (خطوة خطوة) حول أكثر من قضية وفي أكثر من مكان وزمان، ونجحت واشنطن وإسرائيل في خطوات “عرْبَنة الصراعات” إضافةً إلى تقييد مصر عن ممارسة دورها العربي الريادي منذ توقيع إتفاقيات “كمب ديفيد” والتي كان فاتحة عصر المعاهدات والتطبيع مع إسرائيل.
مع هذا التطوّر النوعي في المنطقة الذي حدث من خلال توقيع المعاهدة المصرية/الإسرائيلية في حقبة السبيعينات من القرن الماضي، انتقلت العلاقات العربية/الأميركية من دور الخصومة الى دور “الشراكة”، وكانت أبرز الآمال الأميركية من هذا الدور الجديد تشجيع الأطراف العربية على استكمال “الخطوات” التي بدأت بين مصر وإسرائيل وذلك عبر صيغة مؤتمر مدريد أولاً ثم من خلال الاتفاقيات المنفردة كالاتفاقيات السرّية في أوسلو وما تلاها من اتفاق وادي عربة بين الأردن وإسرائيل.
ورغم ما يظهر على السطح أحيانا من تباين بين إسرائيل وأميركا، فهناك في تقديري غايات كثيرة مشتركة بين الطرفين، وبغضّ النظر عمّن هو الحاكم في إسرائيل أو في أميركا. وهذه المصالح والأهداف المشتركة هي:
1- إبقاء التفوّق العسكري الإسرائيلي على الدول العربية مجتمعة، والضغط على الدول الكبرى لمنع تسليح بعض الدول العربية.
2- فرض العلاقة والتطبيع بين العرب وإسرائيل بغضّ النظر عن مصير قضايا الملف الفلسطيني.
3- السعي لمنع ومحاصرة أي مقاومة مسلّحة للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين كما في لبنان أيضاً.
4– التحفّظ على أي تضامن عربي شامل حتى في حدّه الأدنى وتشجيع الصراعات العربية/العربية التي هي لإسرائيل مصدر قوّة، ولأميركا مبرّرٌ لطلب المساندة منها!.
5- تعطيل التقارب والتفاعل بين العالمين العربي والإسلامي، خاصة مع الجوار الإيراني والتركي، وبالمقابل تعزيز الدور الإسرائيلي في دول العالم الإسلامي، وطبعاً بدعم أميركي.
***
وفي ظلّ هذا الواقع للسياسة الأميركية بالمنطقة، هناك مصالح أميركية مستمرّة فيها (الأمن، النفط، التجارة، تصدير السلاح) ممّا يؤكّد بالنسبة لأميركا أهمية المنطقة استراتيجياً واقتصادياً وأمنياً لسنواتٍ طويلة.
كذلك تدرك واشنطن أنّ سيطرتها الكاملة على المنطقة العربية هو أمرٌ يتنافس مع مصالح دول كبرى أخرى كأوروبا وروسيا والصين، وهذا ما يجعل المنطقة ساحة تنافس دولي، وهو ما يحصل الآن وسيزداد تصاعداً في المستقبل القريب، أضافة إلى التنافس مع مصالح قوى إقليمية كبرى كإيران وتركيا.
أيضاً، هناك صراع على مستقبل هويّة المنطقة، فالعرب يريدونها “هويّة عربيّة”، وأميركا تعمل للهوية “الشرق أوسطية”، وأوروبا تدعو إلى “الهوية المتوسطية”.. طبعاً، مع استمرار السعي الإسرائيلي لبناء “دولة إسرائيل الكبرى”..
وقد سقطت في حقبة التسعينات من القرن الماضي، جملة مفاهيم أو أعذار كانت سبباً أحياناً في سوء العلاقات العربية-الأميركية. ومن هذه المفاهيم – أو الأعذار- الأميركية التي سقطت:
“أنّ أميركا غير عادلة في سياستها بالمنطقة العربية، لأنّ بعض دول المنطقة ترتبط بعلاقات خاصة مع أعداء أميركا الدوليين” (كما كان يقال في حقبة الحرب الباردة مع السوفييت).. وقد سقط هذا المفهوم، ولم تعدّل أميركا من مواقفها تجاه العرب.
“أنّ سياسة أميركا غير عادلة بسبب وجود طروحات اشتراكية وثورية”.. إلخ (كما كان في الستينات من القرن الماضي). وقد انتهت هذه الطروحات، وأصبحت الحكومات العربية منسجمة جداً مع المعايير الاقتصادية الأميركية.. ولم تعدّل أمريكا!!
“أنّ أميركا لا تستطيع العمل الجاد لحلّ الصراع العربي/الإسرائيلي ما لم يتفاوض العرب مع إسرائيل ويعلنوا عن استعدادهم للاعتراف بوجودها من خلال اتفاقيات صلح وسلام”.. وقد حصل ذلك ولم يتغيّر عملياً الموقف الأميركي!.
“أنّ أميركا تريد الاطمئنان أكثر في المجال الأمني بالمنطقة، وتريد معاهدات ثنائية معها”.. وحصلت هذه المعاهدات، وأصبح الوجود العسكري الأميركي أمراً واقعاً ومقبولاً من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي مروراً بمصر والأردن وفلسطين.. وما زالت رغم ذلك أميركا “غير مطمئنّة”!؟.
وحينما تولّت الولايات المتحدة قيادة الغرب أولاً بعد الحرب العالمية الثانية ثمّ قيادة العالم بعد انهيار الإتحاد السوفياتي، كرّرت خطايا المستعمر الأوروبي في أكثر من مكانٍ وزمان، وهي الآن تدفع الثمن غالياً لهذه الخطايا مما يُهدّد دورها الريادي العالمي، تماماً كما حصل مع بريطانيا وفرنسا في آخر حروبهما بالمنطقة، خلال حقبتيْ الخمسينات والستينات من القرن الماضي، والتي كانت فيها مصر- عبد الناصر تقود معارك التحرّر الوطني من المستعمر الأجنبي.
فالقوى الكبرى لم تدرك بعد أنّها رغم تجزئة المنطقة العربية والهيمنة عليها لقرنٍ من الزمن، ورغم وجود دولة إسرائيل الحاجز بين مشرق العرب ومغربهم، ورغم “العلاقات الخاصة” مع بعض الحكومات، حصلت في المنطقة معارك التحرّر الوطني وثورات الاستقلال وحركات المقاومة ومحاولات التوحّد بين بعض الأوطان.
لكن للأسف، فكما أنّ الغرب لم يتعلّم من تجارب (قابلية الإستعمار للانكسار)، فإنّ العرب، في المقابل، لم يتعلّموا أيضاً من (قابلية ظروفهم للإستعمار). فالمنطقة العربية (وأنظمتها تحديداً) لم تستفد من دروس مخاطر فصل حرّية الوطن عن حرّية المواطن. لم تستفد المنطقة أيضاً من دروس التجارب المرّة في المراهنة على الخارج لحلِّ مشاكل عربية داخلية. والأهمُّ في كلّ دروس تجارب العرب الماضية، والتي يتمّ الآن تجاهلها أيضاً، هو درس مخاطر الحروب الأهلية والانقسامات الشعبية على أسسٍ دينية أو إثنية، حيث تكون هذه الانقسامات دعوةً مفتوحة للتدخّل الأجنبي ولعودة الهيمنة الخارجية من جديد.
فالشعوب يمكن تضليلها أو قهرها أو احتلالها لفترة من الوقت، لكن هذه الشعوب لا يمكن أن تقبل بديلاً عن حرّيتها، وبأنّ الأوطان العربية لو تجزّأت سياسياً فهي موحّدة في ثقافتها وفي تاريخها وفي همومها وفي آمالها. فهكذا كان تاريخ المنطقة العربية طيلة القرن الماضي: كرٌّ وفرّ مع المستعمر أو المحتل لكن لا خضوع له. كما كان القرن الماضي حافلاً بالحركات والانتفاضات الشعبية المؤكّدة على وحدة الأمَّة أرضاً وشعباً، وإن ازدادت المسافات بين الحكومات والكيانات بعداً!.
صحيفة رأي اليوم
أضيف بتاريخ :2020/09/08




















